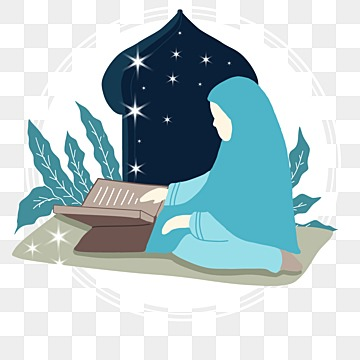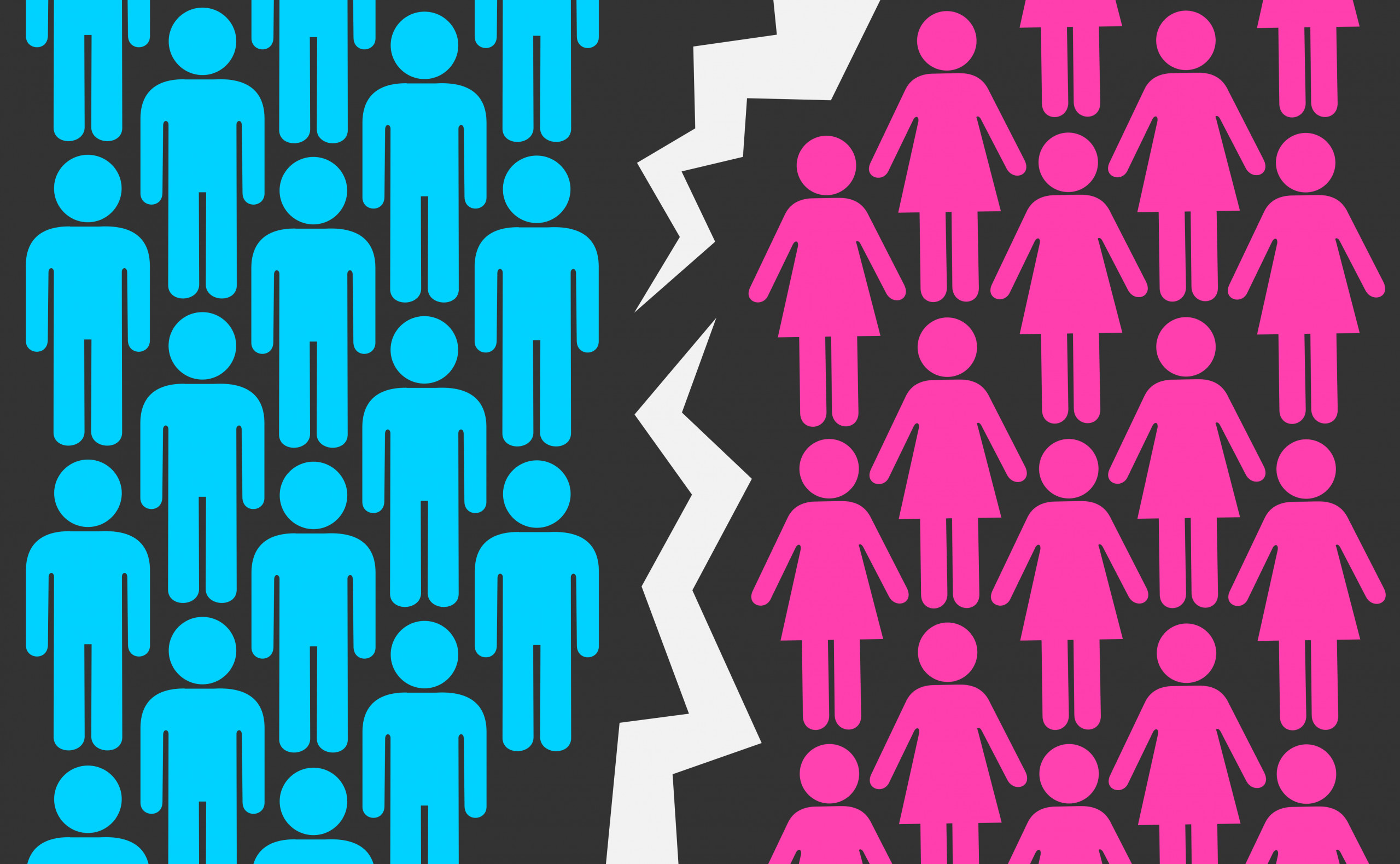يقوم القرآن بثلاثةِ أمور بالنسبة لعواطف الإنسان: يصفُ العواطف، ثم يعطي توجيهًا لكيفيةِ إحساس الإنسان بالعاطفة/الشعور، والأمر الثالث، ينهاه من أن يشعر ببعض العواطف. فهو لا يقوم فقط ـــ أي القرآن ـــ بوصف عواطف الإنسان، وإنما يعطي توصيفًا لكيفية شعوره بعواطفه، ثم ينهاه من أن يشعر بأي شعور من تلقاء نفسه، إذ إن القرآن يُقر بجهل الإنسان ـــ الناتج عن ضعفه ـــ بأن يعرف الإحساس الأصلح له. والكِيان المحرك لمنظومة هذه العواطف ليس الجسد وإنما [الإيمان] وهو مُعتقدٌ وِجداني.
فحينما نقول على سبيل المثال، القرآن يصف عواطف الإنسان، فنحن نعني أن القرآن حَلَّلَ هذا الشعور وهذا الإحساس على وجه الحقيقة الدقيقة المنضبطة والحسية. ثم إن القرآن شرح بوضوح مجموعة عديدة من العواطف كالفرح والحزن والخوف والأمن والطمأنينة، إلخ، وهذا التوصيف عقيدة راسخة للمسلم تعمل له [كإطار مفاهيمي] أو [أنموذج] يُعلِّم المسلمين ويُبَصِّرهم بكيفيةِ تفسير تجاربهم الشعورية.
وعلى الرَّغْمِ من أن هذه الخطوة القرآنية هي الأسهل والأبسط إذا ما قورنت بالخطوتين التي ذُكِرَتَا آنفاً إلا إنها بضخامتها هي المسؤولة عن تفرقة المسلم عن الكافر. فحينما يتم تعريف شعور ما أو عاطفة ما في الفلسفة الغربية أو العلم التجريبي/الحسي، فليس بالضرورة أن المسلمين يقبَلون بذلك التوصيف العاطفي لذلك الإحساس، كالحزن مثلاً، وإنما يؤمن المسلم أن الصواب هو وصف القرآن للحزن، والأمر الآخر في ذات الفقرة، أن القرآن قد يصف بعض التجارب العاطفية بوصف يفتقر العلم الغربي استعماله أو معرفته ولا يدرسه ولا يكترث به= مثال ذلك شعور الهلع، ومن هنا يتميز المسلم عن الكافر بأن لديه دليل عاطفي ثريّ جداً، والأمر الأخير أنه قد يكون هذا الشعور عند الغربيين موصوف بوصف لا يرفضه القرآن، ولكن الخلل أن هذا الشعور لدى الغربيين [هامشي أو يُستعمل في سياقات ضيقة] = كـ(شعور الجزع) حيث إن علم النفس الحديث وفلاسفة الغرب لا يتحدثون عنه كثيراً، ولم أجده إلا في وصف الأطفال الرضع كثيروا البكاء، ولكن حينما تنظر إلى القرآن فتجد استعمالات ذات الشعور (الجزع) قد يكون حاكمًا على يوم الإنسان من أوله إلى آخره. إذن نحن أمام اختلاف في تعريف العاطفة، بين منظور قرآني ومنظور غربي، ونقصان عدد من العواطف الواردة في القرآن لدى الأنموذج الغربي، أو تهميش لمجموعة من العواطف.
أما حينما ننطلق في فهم المجال الآخر للقرآن والذي يُعنى بتقديم طريقة متكاملة في كيفية إحساس المسلم بعواطفه، فالقرآن هنا يقوم مقام الموجّه، وهذا كامنٌ في معتقد المسلم بأن [الأمر] ـــ بمعنى أن الله سبحانه هو الآمر {ألا له الخلق والأمر} ـــ هو الذي يعطي المعنى للشعور، ومن هنا يحدث أعظم تمايز بين المسلم والكافر، ذلك أن مفهوميّ [الجسم] ونشاطه و [الطبيعة] وحاكميتها: فيما يُعنى بالنظام العصبي للإنسان أو الأعراض الجانبية للمرض أو الأعراض الجانبية المصاحبة للصحة كالمداومة على الرياضة، كلها [عاجزة] عن إعطاء المعنى للعاطفة أو تفسير الشعور، وإنما المعنى ـــ كل المعنى لذلك ـــ للشعور ولتلك العاطفة، نابع عن {الأمر}.
فحينما نقول إن القرآن يُعنى بتقديم طريقة في كيفية إحساس المسلم بعواطفه، فإن المسلم بهذا المعنى لا يجد لنفسه أي سبيل إلا في تأدية هذه الطريقة، هو ما يذكره الغربيون في علم الاجتماع تحت مفهوم The Conduct of the Self، أي، أسلوب الفعل. ويشير هذا المفهوم إلى الطرق الدقيقة أو المحددة التي يُبرز من خلالها الإنسان ذاتَه، أو هو الأسلوب الذي يتفاعل به مع الآخرين في الظروف الاجتماعية. [أسلوب الفعل] وهو الأداء المقصود أو المنظم الذي ينسجم وينتظم مع إظهار هويات محددة ومقصودة أو أدوار يطمح الفرد بتأديتها.
ويشتمل أسلوب الفعل إدراك الآخرين (الذين هم في تفاعل مع أسلوب الفرد) لأفعال الفرد في سياق التقاليد والتوقعات الاجتماعية، وهذا يكشف عن معنى غائر في أسلوب الفعل، وهو أنه يتملك حيّزًا من التشريع [الأرضي] الناشئ عن اتفاق الاجتماع الإنساني على سياقات المعاني الثقافية والاجتماعية التي يستند عليها الآخر في تفسير [أسلوب فعل الفرد]، أما الفرق بين أسلوب الفعل والسلوك هو أن كل [أسلوب فعل] سلوك وليس كل سلوك [أسلوب فعل]؛ لأن السلوك يحدث بطريقة لا يُشترط فيها حضور الوعي ولا الإدراك وكذلك لا يتطلب انتظام القصد مع الفعل: القصدية.
ولكن المسلم لا يتقمص [أسلوب الفعل]، ولو فعل فإنه يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير= وهو هنا [القيام بالأمر: أي تأدية العمل الصالح]؛ وأن التوجيهات القرآنية لكيفية شعورنا بالفرح أو شعورنا بالحزن أو شعورنا بالخوف أو شعورنا بالإشفاق أو شعورنا بالرضى أو شعورنا بالخضوع أو شعورنا بالذل أو شعورنا بالأمن أو شعورنا بالسكينة أو شعورنا بالطمأنينة= كلها ناتجة عن “تسليم الذات لأوامر الله تعالى”[1].
فالمسلم يُزاحم التجربة العاطفية الجبليّة/الخَلْقيّة ـــ غير المهذبة بتجربة عاطفية مؤمنة = وهنا يقع التعبد، التعبد لله بهذا المفهوم النفسي هو هذا الإحساس العاطفي الذي نقوم به، مأمورين، بمعنى أن نشعر بشعور ما على وجه ما، بما أمر الآمر سبحانه، كأن نشعر بالخوف على الوجه الذي أمرنا الله به، فلا نخطئ عاطفيًا في الخوف.
فمن هذه المشاعر ما يُعد عباداتٍ قلبية محضة أمرنا الشارع بها وأوقف تجربتنا الإيمانية عليها، كشعور الإخلاص والمحبة والخوف والصبر والرضا والزهد، ومنها ما هو انعكاساتٌ شعورية لهذه العبادات القلبية، مثل {تولوا وأعينهم تفيض من الدمع}، وهذا الدمع انبعثت عاطفته من القلب، ويظهر لي بعد الاطلاع على أقوال الأئمة بأنه ثمرة قلبية لعمل قلبي واحد أو أكثر: فهو بلا شك خوف من الله عز وجل، ويذكر ذلك الإمام الطبري في وصف المؤمنين بأنهم “قوم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالاَخرة”[2] أو أنه محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع خوف، أو أنه خوف مع زهد في الدنيا.، والصواب في وجهة نظري أن جميع هذه المعاني تحتمل المعنى مجتمعة، فهذا من قوة إيمانهم رضي الله عنهم، والله أعلم.
ولكن الذي يميز منهج الإسلام عن منهج علم النفس الحسي أن الإسلام لا يُعبّر عن هذه العواطف بما يُعبّر عنها العلم الحسي، بأنها عواطف أو أحاسيس أو مشاعر على الرَّغْم من إنها تتخذ أوصافًا من هذه كلها، وإنما يتعامل معها الإسلام بناءً على منظومته المفاهيمية الناشئة عن التكليف: كـــ[أعمال] وهذا منعطف ابستيمولوجي رئيس، شديد التمايز والإبانة.
فأولاً، إن الإسلام يجعل الإنسان مسؤولاً بالدرجة الأولى عن كل هذه العواطف التي تدور في خَلَده لأنها “أعمال وأفعال” مكلف بها، ولا يجعل النظام الجسماني حاكم عليها، بل يجعل [الاختيار] نظامًا حاكمًا على الإنسان. يجب الإنتباه هنا أننا لا نتكلم عن العواطف الجبلية التي يسمح بها التشريع بأن تحدث في حدودها الجبلية فقط، وإنما النهي أن تطال المنظومة الجبلية منظومة التكليف ومزاحمة الأمر. ثم إن الإسلام لا يقيم فراغًا للفعل الإنساني سواءً أكانَ الفعلُ مخفيًا في باطنه أو ظاهرًا على جوارحه، فلا مساحة للفراغ الذي لا يحدث فيه أي نشاط إنساني، وإنما ينقسم الفعل الإنساني كله إلى فسطاطين إما أن يكون لله وحده باطنًا وظاهرًا لا شريك له وإما أن يكون للشركاء! ولا يوجد بينهما فراغ أو مسافة في المنتصف فارغة من القصدية.
فما كان لله كان من الإسلام وما كان لغير الله كان في الشرك، سواءً أكانَ شركًا أصغر أو أكبر. والسؤال: ما علاقة هذا بالتجربة النفسية العاطفية؟ الجواب أن الإنسان لا يكبت شعورًا ما فيقف في منطقة فارغة من أي شعور، فراغ [قصدّي]. بل إن ذلك غير ممكن وإنما ينتقل من عاطفة إلى عاطفة ومن شعور إلى شعور، إنما يسلط الإنسان شعورًا على شعور قصدًا، كأن يسلط شعور السكينة على شعور الحزن {… لاَ تَحْزَنْ إِنّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ…}، ولكن المسألة العاطفية أكثر تركيبًا وتعقيدًا من أن تسلط شعور ما على شعور آخر مختلف، وإنما هناك بُعد دقيق يجعل الإنسان يترقى في داخله بين درجات الشعور الواحد من مذمومِه إلى محمودِه ومن سيئهِ إلى حسنِه، أو قل: من الشعور ذو الصبغة الخَلْقية إلى الشعور ذو الصبغة الأمرية ـــ من الخلق إلى الأمر {ألا له الخلق والأمر} فيحدث له بذلك المعنى، ومثاله عدم الإخلاد إلى الخوف الجِبِلِّي [إذا صدر فيه الأمر] {فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ}.
ومن هنا يفترق المسلم عمليًا وعلميًا مع العلم النفساني الحسي بأنه (أي الإنسان) لا يساوي نشاطه الجسماني أو أن الإنسان نتيجة لهذه العواطف التي خضعت لعوامل عديدة كالبيولوجيا والجينات والعوامل الثقافية والاجتماعية والنفسية، فهو على العكس، يقوم بفعل الحزن والخوف وغير ذلك، فهي من أعمال قلبه.
الأهم في هذه المسألة، أن جزءً من هذه المشاعر أو العواطف هي “نفحات ربانية” يستطيع المؤمن أن يتعرض لها من خلال عمله الصالح، فشعور مثل شعور السكينة على سبيل المثال-وليس هو الشعور الأوحد- إنما يُنزّل بما يتعرض له المؤمن من نفحات ومكرمات ربانية، وهذا التعرض لهذه النفحات والهبات الوجدانية من الله مشروطة بما ذكرناه آنفًا في هذه الفقرة تحديدًا بحجم تنفيذ الفعل الإنسان الجُوّانيّ بما هو موصوف في الإسلام بكيف يجب أن يشعر الإنسان، وبعبارة مدونات التراث الأخلاقي في الفكر الإسلامي: مداومته على فعل أعمال القلوب.
وأخيرًا، فإننا حينما جعلنا العواطف في القرآن تكتسب معناها وتفسيرها من (الأمر) لا (الخلق): كالطبيعة البشرية التي جُبِلَ عليها {إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا}، فإنه إذا أصيب بداء أو مرض في فضاء هذه العواطف، فإنه قد أصيب في فضاء الأمر من نفسه، كأن يخاف من الناس ولا يخاف من الله فيحدث له ردة فعل جسمانية تنعكس على صحته، أو كأن يحزن الإنسان بــــ[همّ المعاش] كما يقول الزمخشري، أو [الجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن] كما يقول الطبري ثم يجزع في حزنه، فنقول إنه إنسان أصيب بداء في مجال الأمر لا مجال الخَلْقِ، أي في قلبه، لأن (الأمر) محله القلب، فهو مرض قلبي،ولو انعكس على صحته الجسمانية.
وقولنا هذا منعطف ابستيمولوجيٌّ آخر، إذ أن تقريرنا بإن الإشكال قد حدث في فضاء (الأمرِ) ومحله القلب، فإن هذا يلزمنا بمنظومة تطبيقية في مجال العلم النفساني متعلق بالقلب. وهذا ارتطام بنسق العلم الحسي يجعل العالم النفسانيّ المسلم ملزماً بمنظومة تطبيقية لا توصف بأنها “علمية” لدى الأنموذج العلمي الحسي الحديث في الغرب.
والأمر الثالث والأخير أن القرآن ينهى الفرد من أن يشعر ببعض العواطف كشعور الكِبْر (وعواطف المتكبر: رفض الحق ترفعًا، واحتقار الآخرين)[3]، والحسد (وعواطف الحاسد: البغض والكراهية) والقنوط من روح الله (كاليأس) والرياء والعُجْب والسَّخَط على أقدار الله والرضا بالمحرمات أو تمني الشهوات المحرمة، وفي هذا ينطلق الإسلام من مقدمة أساسية: أن الإنسان لا يستطيع أن يحدد ما لا يصلح له من عاطفة أو شعور أو ما يصلح له إلا من خلال تسليم ذاته لأوامر الله! فينتهج في أفعاله وأحاسيسه ما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه. فباطن الإنسان قلبه، وهو حيز وجودي وِجدانيّ/عاطفيّ ليس هو فيه إلا محلَّ نظر الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز فيه شيء إلا ما أمر به، ولا يدخله إحساس نهى عنه سبحانه، ومن هنا ندرك أن القرآن يؤدي دورًا تكوينيًا في تشكيل الحياة العاطفية للمؤمنين به، من خلال توصيف العواطف (الوصف)، وتقديم التوجيه بشأن كيفية الشعور (التكليف)، والتحذير من بعض الحالات العاطفية أو التعبيرات غير اللائقة من العواطف (المحظور)، والكِيان المحرك لمنظومة هذه العواطف ليس الجسد، وإنما (الإيمان) وهو المعتقد.
[1] الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، (سورة البقرة، آية112 ).
[2] تفسير الطبري (جامع البيان)، (فاطر، آية ٣٤).
[3] شرح النووي على صحيح مسلم.