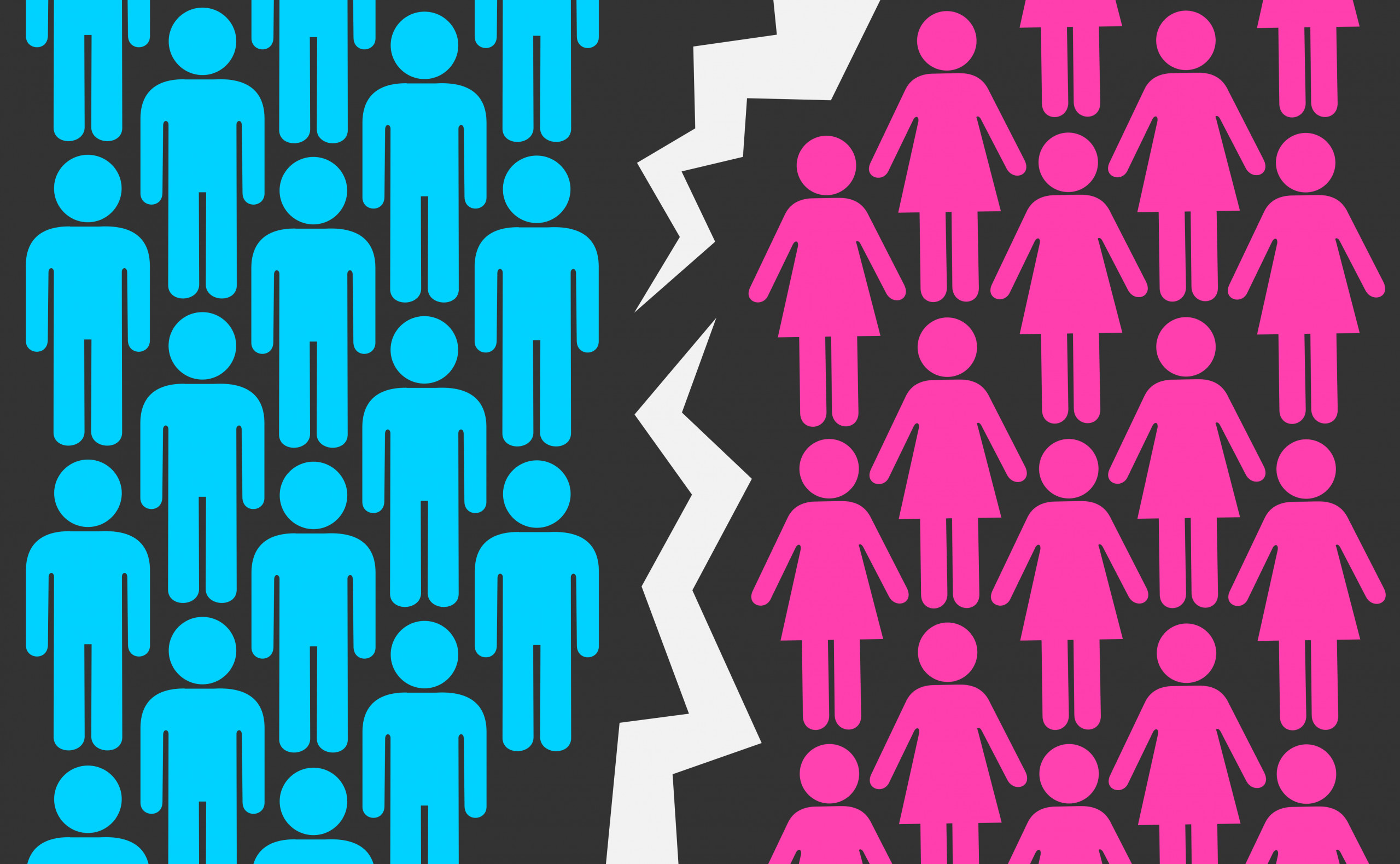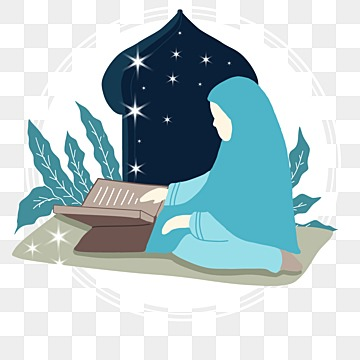بعد قراءات مطولة في قضايا المرأة في زماننا هذا وبين قراءات أيضاً مطولة في تفاسير الآيات القرآنية المتعلقة بالمرأة خلصت إلى هذه النتيجة: وهي أن المفسرين لا يتحرجون ـ في الأغلب ـ مما نتحرخ منه في توصيف المرأة والعلاقة بها. قد يكون السبب كما يزعم كثير ممن يعتنقون النسبية الثقافية أن عدم التحرخ الملحوظ لدى المفسرين عائد إلى أنهم يصدرون عن بنية اجتماعية أبوية وهرمية ضد مبدأ المساواة، وأنهم ينتمون لحقبة تاريخية وصفة ثقافية مخصوصة لا تشبه زماننا الذي قد [تقدم] كثيراً فيه النظر إلى المرأة. ولكن بالرغم من أن هؤلاء النسبيون[1]ينطلقون من مقدمات مغلوطة كحديثهم عن [التقدم] و [التأخر] ذوا الطبيعتين أو الصبغتين الغربيتين، إلا أنه ليس هدف هذ المقال إسقاط هذه المقدمات التي أبان خطأها مفكرين من أمثال إدوارد سعيد وجوزيف مسعد وغيرهم، ولكن الهدف هو تبيين أن الحجة القائلة بأن المفسرين ينتمون لحقبة تاريخية وصفة ثقافية مخصوصة، حجة واهية لأسباب. أولها، أن الحكم على المفسرين يستبطن أنهم من ثقافة واحدة ومن زمن واحد، وهم على العكس من ذلك تماماً. فإن الحقيقة الموضوعية هي أن علماء تفسير القرآن في الحضارة الإسلامية ذوو تنوع ثقافي ومكاني وزماني. وإلا كيف تجد عالماً كالزمخشري من تُرْكُمَانِسْتَان وعالماً من الأندلس كابن عطية وآخر من تونس كالطاهر ابن عاشور ولا تجدهم جميعاً يتحرجون مما نتحرخ منه حينما نتحدث عن المرأة. فهذا يكشف أن الذي يجمعهم ويجعل مواقفهم متشابه ـ بالرغم من الاختلافات بينهم ـ لا علاقة له بالثقافة، وما كانت الثقافة هي التي تجمعهم وتُوحّد مواقفهم، وإنما مناهجهم في التعامل مع هذا النص الخالد. المهم هو أن الثقافة ليست محل الاتهام ولا الاهتمام.
أما شرط الزمان والابتعاد عن تحديات زماننا وظروفه، فكذلك لا يمكن أن يكون سبباً وجيهاً إذا استحضرنا العلامة المفسر محمد الطاهر بن عاشور لأنه من أهم علماء التفسير المعاصرين والذين أسهموا مساهمة كبيرة في تاريخ هذا العلم على وجه الخصوص، وقد أحاطت به قضايا كثيرة هي من مثل التي تحيط بنا اليوم، بل إنه عاش أكثر سنيّ حياته في مناجٍ فرنسي خلال زمن الاستعمار، بل وعاصر قضايا نسوية كثيرة. وبسبب هذه الظروف التاريخية تُعد تونس الأولى في الوطن العربي بالنسبة لقضايا المرأة. فنستطيع القول إنه من أكثر المفسرين الذين اقتربوا من طبيعتنا الثقافية اليوم مع المرأة. إلا أنك تجده متسق مع المفسرين السابقين، وهو من أهم المفسرين لنا أن نتخذه معياراً هنا، لا لأنه فقط يشاركنا التحديات الثقافية المتعلقة بالمرأة، بل لأنه لمع علمياً في قضايا جوهرية كتفسير القرآن ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأفرد حديثاً مطولاً عن الأسرة في المقاصد. ثم إنك حتى حينما تنظر في محاولات محمد عبده ورشيد رضا، وهما النموذجان الأكثر نعومة في تصوراتهم عن المرأة ومعالجتهم لهذه القضايا، إلا أنك تجدهما متطرفين متورطين في تمييزهما ضد المرأة إذا نظرت إليهما بمنطلقات الفكر النسوي والليبرالي.
وهنا يكون التساؤل لماذا لا يتحرك أغلب المفسرين مما نتحرخ منه اليوم؟ وبذلك نكون أمام فرضيتين. الأولى، وهي الفرضية النسوية الكلاسيكية: أن المفسرين أبويين/بطريركيين ويصدرون عن معارف ذكورية، أو يُصدّرون تفسيرات ذكورية يصفون بها المرأة؟ وهذا يفضي إلى معارف ذكورية وهذا هو السبب وراء الدعوات بقراءة أنثوية للنص القرآني. أما الفرضية الثانية: وهي أننا قد (حُمِّلْنَا أثقالاً مِنْ فُهومِ الْقَوْمِ) لم يحملها المفسرين. وهذه الفرضية هي أقرب للصواب عندي لأسباب. أولها، أن الفرضية الأولى تعسفية لا تحترم طبيعة المعرفة الشرعية ولا الخصوصية الدينية والثقافية والمكانية، ولا تسعى للفهم وإنما للحكم على [الآخر]. فهي إسقاط بيّن. والثانية، أن الافتراض الثاني، أوسع من الفرضية الأولى ويشملها. أي أننا متأثرين بالفكر النسوي وهي الأثقال التي تحملها الأذهان اليوم، فحكمنا بحكم المنحاز إلى جهة. والسبب الثالث، هو أن اجتماع المفسرين على هذا الأسلوب وعدم التحرخ منه يكشف عن الطبيعة العربية بين الذكور والإناث المتسامحة مع هذه التعبيرات والتوصيفات المستعملة في التفسير للآيات. بل ويكشف صفاء ونقاء اللسان العربي الذي لم ينظر آنذاك لهذه الإشكالات كما ننظر إليها اليوم. وإلا لو اعترضت النساء العربيات آنذاك لانعكس ذلك على ردود المفسرين وشروحاتهم. ولكن لا أثر لهذا الصراع أو أي نزاع يخص تفسير الآيات ذات العلاقة بشؤون المرأة في أزمانهم إلا زمننا هذا. وهنا ملاحظة يجدر الإشارة إليها تجنباً لسوء فهم فكرة هذا المقال، وهي أن المنهج العلمي في تفسير القرآن منهج يسمح بتداول المعرفة ولا يعاني من مشكلات القوة وتأطيرها للحقيقة لأن علم التفسير ليس علماً بنيوياً. وأن موضوع التفضيل بين الرجال والنساء، واعتبارات التفضيل، وأسبابها، وفوق كل ذلك محدداتها؛ موضوع يستحق الدراسة. وتخطئة رأي فريق على آخر ليس مشكلة. فلا قداسة تمنعنا من تخطئة عالم مسلم، ولا حصانة لمذهب على مذهب أو منهج على منهج. المهم هو ما الذي يريد أن يبني عليه القائل بالتفضيل من أحكام؟ وما الذي يريد الوصول إليه القائل؟
ولكن يبقى السؤال، لماذا يتبنى أكثر أبناء هذا الجيل، وتحديداً المثقفات من النساء، التفسير النسوي الواهن بأن المفسرين أبويين وأننا بحاجة إلى محاولة جديدة لقراءة النص قراءة أنثوية؟
وللإجابة على هذا السؤال يجب أن تكون نقطة البدء هي من طبيعة المناهج أو الأطر النظرية التي تسعى لدراسة المسلم ـ وهو هنا [الآخر] بالنسبة لهذه المناهج من مثل الدراسات الاستشراقية أو ما بعد الكولونيالية أو النسوية. هي معارف تفرض أنساقها المعرفية بصفتين. الصفة الأولى عبر اختلال موازين القوة بين الدارس (الغربي) والظاهرة المدروسة (المرأة المسلمة). والصفة الأخرى هي أن الدراس لم يؤمن يوماً بحقيقة ما ينظر إليه ولا احترم منهجه العلمي (تفسير القرآن) ولا تجربته الحضارية. فالمرأة المسلمة، على سبيل المثال، تحمل رمزية سلبية في منطلقات الغربي المعرفية. وإنك هنا لتستعجب كيف لهذا الخطاب الذي ينطوي على رمزية سلبية عن المرأة المسلمة يريد أن يُنقذها مما يسمى بالخطاب الأبوي عند المفسرين![2]
لذلك، نجد أنفسنا أمام منعطف أبستمولوجي، إن لم يُحسن التعامل معه، سيفضي إلى افتراق طرق وفقدان هويات ونشأت أخرى. إما أن ننظر إلى أنفسنا بعيون الوحي، وأهم ما نثق به هنا هو [المنهج] العلمي لتفسير القرآن عند علماء التفسير. وبالمنهج نستنير في فهم ذواتنا وهويتنا، فإن كان من نقد أو خطأ يراه الدارس، فإن المنهج يسمح بالتقويم والتصحيح. أو أن نترك ذواتنا مرتهنة في نظريات غيرنا، يحكم عليها بمعايير لم تنشأ في أرضنا ولا سقتنا من معين ديننا. وبالتالي، حقيقة هذا النزاع حول من هي المرأة وكيف نتخاطب معها يكمن في الابستمولوجيات والنظرة الوجودية عن الإنسان. وبعبارة أخرى، حقيقة هذا النزاع هو صراع النماذخ والمناهج. ومما يُجلّي هذه الحقيقة هو أن هذا الصراع المناهجي والنزاع ليس حول مسألة واقعة هناك في الخارخ والجميع ينظر إليها من إطاره المفاهيمي. وإنما حقيقة الإشكال [ذاتيّ] قابع في عمق الشخصية الإسلامية، عن لغته ونظرته للمرأة. أي أنها التجربة الذاتية المباشرة عن الشخصية والذات المسلمة مما يعطي المسلم امتيازاً ابستمولوجياً في الإجابة عن نفسه والإعراب عنها. إلا أنك تجدهم ينطلقون من فرضية أن المسلم لا يعرف نفسه، أو أنه بحاجة ماسة للنظر إلى ذاته وشخصيته من خلال منهج غيره. وما كان هذا إلا بانهيار التكافؤ في ميزان القوة المعرفي بين الدارس والمدروس، وهذا هو ما يُسمى بـعنف المعرفة.
وعودة للإجابة على السؤال أعلاه يكفي أن نقول إن المثقف المسلم الذي تأثر بالتفسير النسوي ومنحه الغلبة على الرؤية الوجودية عند المفسرين عن المرأة هو نابع عن إيلافهم صفات الثقافة واللغة والمناهج الغربية والاغتراب اللُغوي والثقافي والعلمي الخاص بحضارتهم العربية، فنتج عن ذلك عجز حقيقي في الإمساك معرفياً ولسانياً وانفعالاً وجدانياً بالهوية العربية والشخصية الإسلامية.
[1] النسبية الثقافية، أي التعامل مع علم التفسير والمفسرين على أنه علم بنيويّ يتأثر بالسياقات الثقافية والاجتماعية والزمانية والمكانية.
[2] ليلى أبو لغد، هل المسلمة بحاجة للإنقاذ؟